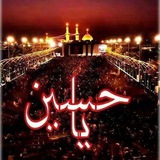Forwarded from القرآن ربيع القلوب
#الحلقة_الثانية
قال الله سبحانه {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا. وَالنَّهَارِ إِذَا جلاهَا.وَاللَيلِ إِذَا يَغْشَاهَا. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا}
في هذه الآيات المباركة عدّة نكات مهمّة يبرز من خلالها مدى اهتمام القرآن الكريم بأخلاق الإنسان وما هو منهجه في دعوة الإنسان إلى الأخلاق الحسنة وتحذيره من الأخلاق السيئة.
ولعل من أهم هذه النكات ما يلي:
#الرابعة: أن مفردات «الشمس» و«القمر» و«النهار» و«الليل» و«السماء» و«الأرض» في الآيات المباركة كلها معرفة غير أن مفردة «نفس» نكرة; إذ قال تعالى {وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا} ولم يقل «والنفس وما سواها».
ولبيان سبب هذا التنكير، ذكرت عدّة وجوه، لعل أفضلها هو ما يشير إليه العلاّمة الطباطبائي في الميزان . من أنه جعل النفس نكرة لبيان عظمتها وفخامتها.
فكأنه (سبحانه) يريد أن يقول ـ والله العالم ـ : يا أيها الإنسان اعرف نفسك لأنك وإن كنت تعرف كثيراً من الأشياء من حولك ولكنّك لا تعرف أقرب الأشياء إليك وهي نفسك، واعلم أنك بهذه النفس التي خلقتها بيديّ ـ وهذه نسبة تشريفية ـ قد أصبحت سيّد عالم الإمكان ومحوره وثمرته بشرط أن تقوم بما يجب عليك القيام به وأن تزكّي نفسك.
والخلاصة، أن عالم الإمكان شجرة إلهية والإنسان ثمرتها وأن هذا العالم يدور حول محور الإنسان الكامل، وفي كل هذه المعاني وما سبقها إشارة إلى عظمة النفس الإنسانية وفخامتها.
#الخامسة: أن الآيات المباركة قد تسلسلت في طرح الأفكار، إذ ورد فيها قوله تعالى: {وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا} ومن بعده ورد قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا}. إذ الظاهر أن للنفس الإنسانية في الإيجاد مرتبتين، كما في قوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى}فأصل الخلق شيء والتسوية شيء آخر.
وهذه التسوية هي المنشأ لقبول النفس إلهام التقوى والفجور {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} وإلاّ فإنها بدون هذه التسوية ليست قابلة لأيّ من الإلهامين.
#السادسة: أكّدت الآيتان المباركتان {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا}حقيقة مهمة وهي أن بإمكان الإنسان أن ينمّي نفسه ويكمّلها من خلال طلبه للأخلاق الحسنة، وإلاّ لو لم يكن ذلك بإمكانه لما أشارت الآيتان إلى فلاح من يزكي نفسه وخيبة من يدّسها.
وهذه مسألة ترتبط ببحث الجبر والاختيار، فلو قيل بأن الإنسان مجبر على أفعاله، فهذا يعني أنه لن يكون بإمكانه طلب الأخلاق الحسنة اختياراً، فلا معنى لأن يُحثّ على طلبها.
غير أن هذا القول تفنّده الآيتان المباركتان من خلال حثهما الإنسان على التخلّق بالأخلاق الحسنة، وهو ما يدل على إمكانية ذلك من جهة، وعلى بطلان فكرة أن الإنسان مجبر على أفعاله من جهة أخرى.
@hu3e3
قال الله سبحانه {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا. وَالنَّهَارِ إِذَا جلاهَا.وَاللَيلِ إِذَا يَغْشَاهَا. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا}
في هذه الآيات المباركة عدّة نكات مهمّة يبرز من خلالها مدى اهتمام القرآن الكريم بأخلاق الإنسان وما هو منهجه في دعوة الإنسان إلى الأخلاق الحسنة وتحذيره من الأخلاق السيئة.
ولعل من أهم هذه النكات ما يلي:
#الرابعة: أن مفردات «الشمس» و«القمر» و«النهار» و«الليل» و«السماء» و«الأرض» في الآيات المباركة كلها معرفة غير أن مفردة «نفس» نكرة; إذ قال تعالى {وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا} ولم يقل «والنفس وما سواها».
ولبيان سبب هذا التنكير، ذكرت عدّة وجوه، لعل أفضلها هو ما يشير إليه العلاّمة الطباطبائي في الميزان . من أنه جعل النفس نكرة لبيان عظمتها وفخامتها.
فكأنه (سبحانه) يريد أن يقول ـ والله العالم ـ : يا أيها الإنسان اعرف نفسك لأنك وإن كنت تعرف كثيراً من الأشياء من حولك ولكنّك لا تعرف أقرب الأشياء إليك وهي نفسك، واعلم أنك بهذه النفس التي خلقتها بيديّ ـ وهذه نسبة تشريفية ـ قد أصبحت سيّد عالم الإمكان ومحوره وثمرته بشرط أن تقوم بما يجب عليك القيام به وأن تزكّي نفسك.
والخلاصة، أن عالم الإمكان شجرة إلهية والإنسان ثمرتها وأن هذا العالم يدور حول محور الإنسان الكامل، وفي كل هذه المعاني وما سبقها إشارة إلى عظمة النفس الإنسانية وفخامتها.
#الخامسة: أن الآيات المباركة قد تسلسلت في طرح الأفكار، إذ ورد فيها قوله تعالى: {وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا} ومن بعده ورد قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا}. إذ الظاهر أن للنفس الإنسانية في الإيجاد مرتبتين، كما في قوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى}فأصل الخلق شيء والتسوية شيء آخر.
وهذه التسوية هي المنشأ لقبول النفس إلهام التقوى والفجور {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} وإلاّ فإنها بدون هذه التسوية ليست قابلة لأيّ من الإلهامين.
#السادسة: أكّدت الآيتان المباركتان {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا}حقيقة مهمة وهي أن بإمكان الإنسان أن ينمّي نفسه ويكمّلها من خلال طلبه للأخلاق الحسنة، وإلاّ لو لم يكن ذلك بإمكانه لما أشارت الآيتان إلى فلاح من يزكي نفسه وخيبة من يدّسها.
وهذه مسألة ترتبط ببحث الجبر والاختيار، فلو قيل بأن الإنسان مجبر على أفعاله، فهذا يعني أنه لن يكون بإمكانه طلب الأخلاق الحسنة اختياراً، فلا معنى لأن يُحثّ على طلبها.
غير أن هذا القول تفنّده الآيتان المباركتان من خلال حثهما الإنسان على التخلّق بالأخلاق الحسنة، وهو ما يدل على إمكانية ذلك من جهة، وعلى بطلان فكرة أن الإنسان مجبر على أفعاله من جهة أخرى.
@hu3e3
🚩۩نـدٱءٱلـعـقـيـدة۩🚩
Photo
#تابع🙏👆🌷
#ثنائية_الدين فصل(1)
.
👈 #الثالثة: التسليم بتعبدية بعض القوانين:
لكل نظام من النظم العقلائية قوانين وتشريعات تعبدية تصدر من أصحاب القرار لمصلحة تقتضيها وقد لا يملك الأفراد عللها وأسبابها ويكون المطلوب منهم الموافقة عليها، والالتزام بها.
ولا يختلف الاسلام عن تلك الأنظمة البشرية والعقلائية لأن الشارع المقدس من العقلاء، بل هو سيد العقلاء ورئيسهم، مضافاً لكونه خيراً وأفضل منها، وهذا يعني أنه يتضمن جملة من القوانين والتشريعات التي لا يملك العقل البشري القدرة على الإحاطة بعللها وأسبابها، فوظيفته هي التعبد بها والعمل على وفقها، فعدد ركعات صلاة الصبح مثلاً، أو الظهرين، لا يملك الإنسان السر في ذلك، ولماذا جعلها الشارع هكذا. وما هو السبب في عد تعمد البقاء على الجنابة من المفطرات. ولماذا لا تصح معاملات الصبي؟ وما هو الداعي لجعل عدة الوفاة على المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها؟ ولماذا تجعل عدة الطلاق على المرأة التي ثبت أنها غير حبلى، وهكذا.
ومن ضمن هذه الأمور ما يرتبط بمسألة العقيدة والحرية الفكرية، فعندما يجعل الحد على المرتد مثلاً، يكون ذلك أمراً تعبدياً، وليس من الضروري أن يملك الإنسان القدرة على الإحاطة بأسبابه والوقوف على علله ومناشئه.
وهذه نقطة مهمة، يلزم على كل من يود النقاش أن يسلم بها، حذراً من أن يكون النقاش والبحث جدلياً وسفسطائياً، وهكذا.
👈 #الرابعة: مفهوم الحرية، وتحديد المقصود منه:
🔹وقع الجدل كثيراً حول هذا المفهوم وبالتحديد في بيان المقصود منه، وتحديد حقيقته وذلك بسبب استعماله في مجالات متعددة ومختلفة من العلوم. نعم يمكن استخلاص معاني أربعة أساسية متميزة لها:
⭐️١-معنى خُلقي، وهو ما كان معروفاً في الجاهلية وحافظ عليه العرب.
⭐️٢-معنى قانوني، وهو المستعمل في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى:- (فتحرير رقبة)[4].
⭐️٣-معنى اجتماعي: وهو يطلق على من يكون معفواً عن الضريبة فيقال له حر.
⭐️٤-معنى صوفي: وهو الخروج من رق الكائنات[5].
والمتحصل من هذه المعاني هو أنها تركز على عنصر الإنسانية كأساس فطري للحرية، ولهذا نجد أن الموسوعةالاسلامية الميسرة قد عرفتها بأنها: القدرة على الاختيار بين الممكنات بما يحقق الإنسانية[6]. وكيف ما كان، فإن الواجب على كل من بلغ مرحلة التكليف أن يتخذ دين الله سبحانه وتعالى عقيدة، ويعتنقه، نعم قد خلى نظام التشريعي الإسلامي من قانون يجبر الإنسان بموجبه على هذا الأمر، وهذا ما دعى البعض أن يتصور حرية الانسان المطلقة في أن يتعبد بما يشاء ويعتنق ما يريد، فجاءوا يقررون أنه يحق لكل فرد أن ينتخب ما يشاء ويتبنى ما يرغب أن يعتقد، ولم يكتفوا بذلك، بل تمسكوا لذلك ببعض الآيات القرآنية، التي قرروا دلالتها على مدعاهم.
#الهوامش
[4] سورة البقرة الآية رقم 92.
[5] مجلة الاجتهاد والتجديد العدد 8 ص 136.
[6] الموسوعة الإسلامية الميسرة ج 4 ص 869، نقلاً عن مجلة الاجتهاد والتجديد العدد 8 ص 155.
#ثنائية_الدين فصل(1)
.
👈 #الثالثة: التسليم بتعبدية بعض القوانين:
لكل نظام من النظم العقلائية قوانين وتشريعات تعبدية تصدر من أصحاب القرار لمصلحة تقتضيها وقد لا يملك الأفراد عللها وأسبابها ويكون المطلوب منهم الموافقة عليها، والالتزام بها.
ولا يختلف الاسلام عن تلك الأنظمة البشرية والعقلائية لأن الشارع المقدس من العقلاء، بل هو سيد العقلاء ورئيسهم، مضافاً لكونه خيراً وأفضل منها، وهذا يعني أنه يتضمن جملة من القوانين والتشريعات التي لا يملك العقل البشري القدرة على الإحاطة بعللها وأسبابها، فوظيفته هي التعبد بها والعمل على وفقها، فعدد ركعات صلاة الصبح مثلاً، أو الظهرين، لا يملك الإنسان السر في ذلك، ولماذا جعلها الشارع هكذا. وما هو السبب في عد تعمد البقاء على الجنابة من المفطرات. ولماذا لا تصح معاملات الصبي؟ وما هو الداعي لجعل عدة الوفاة على المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها؟ ولماذا تجعل عدة الطلاق على المرأة التي ثبت أنها غير حبلى، وهكذا.
ومن ضمن هذه الأمور ما يرتبط بمسألة العقيدة والحرية الفكرية، فعندما يجعل الحد على المرتد مثلاً، يكون ذلك أمراً تعبدياً، وليس من الضروري أن يملك الإنسان القدرة على الإحاطة بأسبابه والوقوف على علله ومناشئه.
وهذه نقطة مهمة، يلزم على كل من يود النقاش أن يسلم بها، حذراً من أن يكون النقاش والبحث جدلياً وسفسطائياً، وهكذا.
👈 #الرابعة: مفهوم الحرية، وتحديد المقصود منه:
🔹وقع الجدل كثيراً حول هذا المفهوم وبالتحديد في بيان المقصود منه، وتحديد حقيقته وذلك بسبب استعماله في مجالات متعددة ومختلفة من العلوم. نعم يمكن استخلاص معاني أربعة أساسية متميزة لها:
⭐️١-معنى خُلقي، وهو ما كان معروفاً في الجاهلية وحافظ عليه العرب.
⭐️٢-معنى قانوني، وهو المستعمل في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى:- (فتحرير رقبة)[4].
⭐️٣-معنى اجتماعي: وهو يطلق على من يكون معفواً عن الضريبة فيقال له حر.
⭐️٤-معنى صوفي: وهو الخروج من رق الكائنات[5].
والمتحصل من هذه المعاني هو أنها تركز على عنصر الإنسانية كأساس فطري للحرية، ولهذا نجد أن الموسوعةالاسلامية الميسرة قد عرفتها بأنها: القدرة على الاختيار بين الممكنات بما يحقق الإنسانية[6]. وكيف ما كان، فإن الواجب على كل من بلغ مرحلة التكليف أن يتخذ دين الله سبحانه وتعالى عقيدة، ويعتنقه، نعم قد خلى نظام التشريعي الإسلامي من قانون يجبر الإنسان بموجبه على هذا الأمر، وهذا ما دعى البعض أن يتصور حرية الانسان المطلقة في أن يتعبد بما يشاء ويعتنق ما يريد، فجاءوا يقررون أنه يحق لكل فرد أن ينتخب ما يشاء ويتبنى ما يرغب أن يعتقد، ولم يكتفوا بذلك، بل تمسكوا لذلك ببعض الآيات القرآنية، التي قرروا دلالتها على مدعاهم.
#الهوامش
[4] سورة البقرة الآية رقم 92.
[5] مجلة الاجتهاد والتجديد العدد 8 ص 136.
[6] الموسوعة الإسلامية الميسرة ج 4 ص 869، نقلاً عن مجلة الاجتهاد والتجديد العدد 8 ص 155.